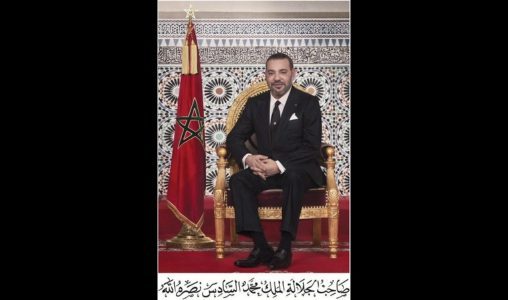المعرض الاستيعادي للفنان التشكيلي عبد الإله الشاهدي… برواق المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط

تحت عنوان ” ما وراء نظرة”، يحتضن رواق المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط بدعم من وزارة الثقافة المعرض الاستيعادي للفنان التشكيلي عبد الإله الشاهدي ما بين 14 و 31 دجنبر الجاري.

فَـوْرَة الحَــواسّ
ظل الكائن البشري يستأثر باهتمام المبدعين على اختلاف مشاربهم طيلة سيرورة تاريخ الفنون بجميع أجناسها وأصنافها. والحال أن “الإنسان” كموضوعة جوهرية متعددة الجوانب والدلالات والخلفيات، اتخذت جوهر اشتغال تعبيري لدى الفنان/ الإنسان، كتمَحْوُر – بوعي أو بدون وعي – حول الذات في بُعْدَيْها الجسماني والروحي، المظهري والباطني، المادي والنفسي. مثل هذه الأبعاد المتداخلة، الظاهرة منها والخفية، لم تكن غفلا في فن النحت (الذي طالما جعل من الجسد سلطان التعبير) وفن الجُدرانِيات Les fresques، وفن الأيقونات (الرسوم التصغيرية)، وفن التصوير La peinture، بالرغم من كون هذه الفروع الإبداعية تؤكد على الصورة البشرية في مظهرها الفيزيقي كموضوع بصري بالدرجة الأولى.
في هذا المنحى تندرج التجليات الجسمانية في لوحات عبد الإله الشاهدي الذييُقحم الأجساد النسوية في محيط الوجوه الأنثوية المُكَبَّرَة بعناية، فيما يغدق عليهابالسَّوائِل والأنسجة الطحلبية لترطيب مظاهر العري فيها، لتدفع المَشْهَدِية بالمشاهد إلى تمَثُّل مناظر طبيعية مفعمة بهبوب الرياحوجداول الشلالات في حُلَّة فانطاستيكية متَخَيَّلَة. من ثمة، يتخذ التشكيل صفة التمويه بين إيقاع الحَجْب والكشف، التغطية والإبقاء، دون مَحْو معالم الترسيم الدقيق للجسد الناعم، أي دون المساس بالعُرْي في نهاية المطاف. إنها الطريقة التي تجعل الكِساء مَطِيَّة لتَمَظْهُر في غاية التدبير، ذلك في الحين الذي لا يمنح فيه العُرْي بشكل مباشر، مع الأخذ في الحسبان سمة التصغير المُدمَجَة ضمن تنشيط الخلفية Le fond السائر نحو العُمق المتباعد مع النموذج المحوري في اللوحة.
تبقى هذه الأجساد المُصَغَّرَة عبارة عن امتدادات الوجه الأساسي في اللوحة، لنشير إلى خاصية البورتريهLe portrait البارزة أكثر فأكثر في اللوحات، ومعه نبقى باستمرار في ثيمة الجسد، على اعتبار الوجه يُشكِّل الصورة الشاملة والمختزلة للجسد، هو ما يأتي في رُتْبَة الرِّفْعَة أعلاه ليمُدَّه بجوهر الحواس،وهوما يمنحه هويته الصورية والروحية. من ثمة، فإن البورتريهات الأنثوية، إنما هي أبدان في حد ذاتها، تختزل فتنة أجسادها في حروفها وتقاسيمها ونظراتها، وما الأجساد النسائية المحمومة، المختصرة في الحجم، والمتلاحمة حول قطب المُحَيّا، إلا صورا حيوية موحية لوضعيات عضوية لذات الوجه الذي يكاد يملأ المساحة بكاملها. بينما الفضاء الذي يُؤَلِّف بين ثبات السحنات ودينامية الجَسَدانِيَّة المُغَلَّفة بالسيول المِهراقة، تنصهر من خلاله أجواءإيروسية موصولة بدفق شبقي.
هذه المقاربة الدائرة في فلك المرأة، تقوم هنا على نمط تمثيلي يستجيب لقواعد التصوير الأكاديمي عند الشاهدي، من حيث الرسم le dessin، ومن حيث معالجة الضوء والظل والتدرجات اللونية بدقة الكلاسيكيين، فيما تفرز ألوانه درجة من الإشعاع “الضوئي” الذي يمكن تلَمُّسه في الظلمة، وهذا من سرائر كيمياء مواده. فبعيدا عن محاكاة المرئي كما تستقبله العين، يُسخِّر تمكنه التقني في تعميق أسلوبه الذي يتَمَثَّل صور الواقع لاقتطاع ما يختاره منهالبناء عالم تركيبي ينهل من الخيال والحلم، ومن المُساءلة المستمدة من قضايا مجتمعية ونفسية مُعاشَة، تمس وضع المرأة بالدرجة الأولى، لكن في قالب رمزي مستفز ورائق في نفس الآن. هكذا يُخْضِع التشخيص إلى الترميز الذي يحيل على ما يعتور المرأة العربية من تضييق ومعاناة وسلب للحريات على اختلاف أبعادها. ومن ثمة، يضعها وراء شباك بيَدَيْن ماسِكَتَيْن على سلكه بقبضة عنيدة ونظرة متطلعة لأفق منفتح. فيما يولي أهمية بالغة للعين الشديدة النصع، مع التأكيد على صوغ عمق النظرة القوية، والقاطعة، والحادة، والحالمة بدورها، حيث بريق البؤبؤ لغة إشارية، تثير توق الرغبة بالهمس، بقدر ما ترسم إعلان التحدي والطموح بالجهر.
إننا بصدد صياغات تعبيرية تجعلنا أمام أجساد وبورتريهات نسائية بمستويات مُقَرَّبَة (Plan rapproché) في فضاءات مُشَوِّقَةومُضاءَة بشدة، على شاكلة سينوغرافيا مجسدة تحت إنارة كاشفة، حيث الغرافيك والتفاصيل الجزئية تعمل على تكثيف مشاهد البذخ الأنثوي، في حالات القوة والانكسار، حالات الحلم والتأمل، ضمن فرجة تتخللها نبرة سريالية بادية، من خلال اعتماد خاصيات تصدف عن منطق الواقع المرئي،كالمبالغة (Exagération) في عمليات التكبير والتصغير، وتبديل حلقة الأذن بصخرة ثقيلة، واستبدال حبات الرمل داخل زجاج الساعة الرملية بوجه امرأة حسناء في الأعلى وأخرى عجوز في الأسفل كدلالة على قدرة الزمن في حفر التجاعيد ومسخ إشراق الوجه،وكذا تعليق وجوه النساء على حَوامِل المَعاطِف كدلالة على تغييرها المتكرر (من قبل الرجل) الذي يؤدي إلى تشييء (Chosification) المرأة. مثل هذه التحويلات البصرية وغيرها، تزيح المرأة من هيمنة النَّظَر إليها باعنتبارهاقيمة للجمال والزينة والنسل فحسب، فيما تُوَسِّع مجال القراءة والتأويل، وتُوَلِّد المعاني والدلالات والاستفسارات القمينة باستحضار المبادئ والمواقف والسياقات.
في هذه الأعمال التي يتناغم فيها البشري والحيواني (الطيور بخاصة) والطبيعي، تستوقفنا المَشاهِد لاستدعاء مُدَّخَرات الرموز والأساطير، كاسترجاعات سياقية تزكي الشروط الإبداعية للاحتفاء بالمرأة الموصوفة بالحُسْن والخصوبة وفيض الطبيعة، وقد ظلت تشكل موضوع اشتغال عدد من التجارب في مسار الفن المغربي (مريم مزيان، كمال بوطالب، عزيز السيد، عبد الباسط بن دحمان). هكذا أرادها الفنان عبد الإله الشاهدي في فردوس لوحاته التي تقذف بنا في فورة الحواس، في مقام التعدد دون كلل، حيث المُحَيّا الناعم الممسوس بانهمار الماء، تكثيف مجازي للطاقة والحياة، وشعرية رامزة للذات والذاكرة.
بنيونس عميروش
تشكيلي وناقد فني
الرباط، نونبر 2018

تحولات الوجه في لوحات عبد الإله شاهدي
شكل الوجه رهانا فكريا وجماليا في كافة الفنون البصرية، وقد استمال ثلة من الفنانين للبحث في ما يحبل به من رهانات فنية وفلسفية متنوعة،ويعبر هذا الفعلفي جوهره عن تطور نظرة الإنسان لذاته، وإعلانه الصريح عن أناه الفردية والغيرية التي طَمَرَتْهَا تراكماتٌ ميتافيزيقية كثيرة، دَحَرَتْها إيديولوجيات كثيرة… وهو ما استتبعته تساؤلات حارقة وعميقةحيال علاقة الإنسان بذاته وبغيره وبالعَالَم، فأن ترسم الوجه، معناه أن تَنْشَدَّ إلى ذلك الجزء الأمامي من الرأس، المرتبط بما هو حميمي في الإنسان، وتلك مغامرة شيقة تواجه فيها الذات ذاتها؛ إذ يضع خلالها الفنان وجهه أمام المرآة كي يتأمله، وذلك عن طريق ترويضه وتأطيره وإدخاله ضمن أنساق جمالية ورمزية لاتخلو من المواجهة التي تشحذ الإلهام، وتسائل مختلف التدخلات التي تطرحها أهم الأنظمة المُؤَطِّرَة للوجه (جمالية،سياسية، تربوية، دينية، جنسية…).
قريبا من تلك الخلفية، وانسجاما مع أسئلتها، يتجاوز الاشتغال الفني على الوجه في لوحات عبد الإله شاهدي المقاربة البورتريهاتية التي تتعامل مع الوجه كألوان وسحنات، مقاسات وأبعاد، أضواء وظلال، منعطفات ومنعرجات، انحناءات وانكسارات.. لتحاول القبض على التحولات التي تطاله ضمن المسيرة الأنطولوجية للإنسان ككائن عانى من أجل أنيتطور عبر الزمن. وما الوجه في اللوحة إلا انمساخ وتحول ومرور من حالة إلى أخرى حيث لم يكن ذلك سهلا ولا بسيطا: معاناة ومكابدة، انفراج وانشراح، صراع وتوتر، حب وشبق…
صحيح أن الوجه الأنثوي، يهيمن على اللوحات، وهو ما يعكس وعي الفنان أو لاوعيه، ويمكن أن يؤشر عن مدى التزامه بقضية المرأة وموقفه من واقعهاخصوصا في السياق الثقافي العربي والإسلامي الذي يريد أن يواري وجهها (شخصها)، ويضعه خلف حجاب أو سياج تحركه أو تتحكم فيه أصابع معروفة/مجهولة…وهي موضوعات استطاعت اللوحات وضع الوجه ضمن اشتغالاتصباغيةاستدعت آليات الانزياح الرمزي داخل اللوحة: النحت على الصخر (الوجه المنحوت)، المواجهة السيزيفية، الدخول إلى المغارة المنعزلة في أعلى القمم الجبلية وأشرسها، تشجير الوجه، وضعه في مدارات الساعة الرملية، إحراقه بالشمع أو تشميعه…
تُؤَشِّرُ الخيارات اللونية المائلة إلى الشحوب والقتامة على هذا المنحى المأزوم الذي يتجاسر ويتكاثف ليضاعف معنى الإذعان والخضوع، الاستسلام والدونية، بل الإباء والتعالي الذي تحيل عليه نظارة الوجه والعناية به، وانفتاح العيون ويقظتها، فكلما تقلص حجم الوجه داخل مساحة اللوحة تختصره النظرات والملامح، وهي دلالات تسهم في تكثيف المعنى الذي تسعى اللوحات لبلورته في شكل مفاهيم تجعلها دالة على الرسائل التي يسعى عبد الإله شاهدي إلى تبليغها، وحَفْزِ المتلقي على التماهيمعها، ودعوته على التعامل مع الوجه الأنثوي بشكل منفتح يتجاوز الإيحاء الإيروتيكي، فالوجه ليس مجرد واجهة منفصلة عن الباطن، وهي ليست مجرد رمزللروح،بلهي روحالشخصية.
تستدعينا اللوحات إلى تجاوز الوجه كواجهة – غير بسيطة طبعا – والانغماس فيما وراء القناع، فإذا كان الوجهيعنيالرائي والمرئي، فإنه يعني اللامرئي والمحجوب…وهو الأمر الذي يدفع إلى القول بأن الوجه لايفكر دون مساهمة الآخرين، أي دونَ وجهٍ آخرٍ.. الوجه في اللوحة عاكسٌ للثقافة التي يتحرك في سياقها، يتلونُ بألوانها، يأخذ نَظَارَتَهُ منها، يعززُالروابطبين الأضداد، ويوطد الشعور بالأنا داخل المجتمع. مع ذلك، فهو في نظر مبدعه، لا ينفصل عن المبادئ الرائجة في محيطه، والتي لاتزالتظهرمتأرجحة الوضوحوالبروز، ولا تستطيع الإعلان عن نفسها بحرية؛ إذ بالرغم باتصافها بالحداثة،وسعيها للتحرر، فهي تظل بعيدة كل البعد عن الإجماع (وجه مسجون وشاحب).
يبدو أن الوجه في لوحات عبد الإله شاهدي الفنية يظل مرتبطا بالجزء العلوي للإنسان، وبرأسه بالضبط، وهو ما يحيل على التقنيات الفنية المنفتحة على نحت التماثيل النصفية،والفوتوغرافيا المرتبطة بالبورتريه، واللقطات التفصيلية المُؤَطِّرَة للوجه في السينما.. والتي تسعى في مجملها، ومنذ فترة طويلة، إلى البحث عن التناغم الموجود أو المفقود مع الصورة المثالية للإنسان. لقدظَلَّ هذا الهاجس رهانا كونيا للإنسانية،باعتباره حاملا للقيم والمواقف العاكسة لمفهوم الحضارة الإنسانية. يمكننا القول في سياق هذا المنظور الإنساني أن الوجه في اللوحة الصباغية لايشبه نظيره في النحت، ذلك أنه “محروم من العين ونظرة الروح” ،وفق منظور الفيلسوف هيجل، وبهذا فلا يمكنه مضاهاة جماليات الوجه التي تظهر في اللوحة.
ترمي هندسة الوجه في لوحات عبد الإله شاهدي إلى التحايل على استراتيجيات تقديمه المعتادة، والسعي إلى إعادة ترتيب النظام الذي تخضع له خطوطُ رسمه بعيدا عن الدخول في ضيق الحسابات الشكلية، فهي تسعى – بدرجات متباينة -إلى تفكيك البناء وإعادة التشكيل؛ إذ بالرغم منرسوخ تلك الاستراتيجيات في الممارسة الصباغية الخاصة برسم الوعي، فإن تعميق رمزية الوجه،والحفر في تعبيريته ورمزيته، والإضافة إلى ما أنجزه الفنانون السابقون، يتأسس على تقديمه في حلة جديدة: الوجه كإمكانية متجددة للمقاومة…الوجه كسلاح.
الوجه شيء مختلف، تماما، عن البورتريه.
محمد اشويكة
كاتب وناقد جمالي

نساء عبد الإله الشاهدي.. الصور باعتبارها واقعا سحريا.
عزالدين بوركة
تتعدد اصطلاحات المرتبطة بالواقعية المفرطة Hyperréalisme، فهذا التيار الفني المفرط في واقعية صوره، يخلق تنافسية جمالية بين يد الفنان وأساليبه المختلفة والآلة الفوتوغرافية؛ هذه الآلة التي شكلت ثورة كبرى في تاريخ الفن -خاصة منذ العقد الأخير من القرن التاسع عشر. وقد ارتبطت الواقعية المفرطة بالفن المعاصر، باعتبارها إحدى الفنون التي مهدت وساهمت في بزوغ فجر هذا الفن، إلى جانب واقعية الـ”بوب آرت” pop’art وغيرها… الفن المعاصر الذي سعى إلى جعل الإنسان مسعاه ومنطلقه. الإنسان في أقصى حالات التشتت والتشرذم والانفلات والهشاشة، أي في يومياته ويومه. هذا السعي يبتغي تجاوز الإنسان في ذاته، عبر رؤية نيتشاوية ترنو إلى بلوغ ذلك الإنسان الأسمى والأعلى، السوبرمان superman.
تندرج أعمال فنانين مغاربة قلة في خانة التصويرية المفرطة في واقعيتها، وإن حاول البعض إدراج أسماء معينة ضمن هذا التيار، إلا أنه إدراج -عندنا- كان عن غير وعي -أو عن قصد- أو عن غير إدراك، لما تحمله هذا التيار من أسلوبية ودقة عالية، من حيث التدقيق والتصوير. يعد الفنان التشكيلي عبد الإله الشاهدي من هؤلاء الفنانين القلائل الذين استطاعوا -في المغرب- عبر تمرس وتمدرس واشتغال وتجريب داخل مختبره /ورشته، أن يمتلك ناصية الدقة في التصوير والصباغة التصويرية.
فهذا الاتجاه الفني سعى إلى الإعلاء من الكائن البشري، إذ بجعله يتمتع بحرية ووجود كامل.. حيث أنه في غالبية أعمال المنتمين لهذا الفن يحضر الإنسان باعتباره مركز اشتغالهم، وذلك في كامل حريته اللامشروطة. أي باعتباره (أي الإنسان السامي) بديلا عن “السماء التي أضحت فارغة”.
ولأن السماء فارغة كان لزاما “استرجاع الأشياء التي تم انفاقها في السماء إلى الأرض” (فيورباخ)، هذه الأرض التي يربحها الفن كلما فقدتها الميثولوجيات… إننا نربح الأرض كلما خسرنا السماء. إننا إذن نربح الجسد ونخسر الروح. إذ إننا نوجد باعتبارنا أجسادا لا أرواحا تتقاسم معنا الجسد. من هذا المعطى النيتشاوي الذي تبلور على يد ميرلوبونتي، من حيث تأكيده على إدراكنا للعالم بكامل أجسادنا، سعت الفنون المعاصرة، المستندة على فلسفة، أو فلسفات ما بعد الحداثة، إلى إعلاء الإنسان بصفته موجودا بالجسد.
ومن جانب آخر، ولأن الواقع مأساوي ودموي ومليء بالحروب والشرور، فنحن “نملك الفن بهدف ألا نموت من الحقيقة”. لكن أية حقيقة؟ إنها حقيقة الواقع، أو حقائق الواقع. لهذا جاءت الواقعية المفرطة باعتباره واقعا بديلا، واقعا فنيا يحدد زواياه وإطاره ودقته الفنان عينه، إن الواقع السحري. جاءت كتعويض عن السماء الفارغة. فيغدو الفن حاميا من “القرف والانتحار”، فننتصر للكائن في كامل جسده.
من هذه الخلفية الفلسفية والفنية تتأسس أعمال الفنان التشكيلي المغربي عبد الإله الشاهدي -المولوع برسم الأنثى، باعتبارها أساسا بصريا ترتكز عليه أعماله جلها، وذلك في بعد واقعي مفرط في الواقعية. من حيث أن هذه الواقعية الجديدة جاءت كمحاولة فنية مختلفة وبديلة عن التأزم الذي خلقته التجريدية -والتجريدية التعبيرية- حينما بلغت ذروتها وأقصاها الفني أواسط القرن الماضي. لهذا نجد أعمال عبد الإله الشاهدي عامرة بانطباعية وحساسية مفرطة، يجسدها الفنان عبر تلك الخلفيات السوريالية المتولدة عن تداخلات شكلية وصباغية غرائبية وسحرية. تجعلنا أمام سديم سماوي تتولد عنه تلك “السيدات الجميلات”. فالفنان هنا يسعى إلى أخذ التصوير إلى مضاهاة آلة الفوتوغرافية، عبر عملية الإدراك البصري في أقصى ما يمكن أن تسجله العين. وذلك من حيث أن الواقعية المفرطة كتيار معاصر سعى إلى “تصوير وجوه النساء الجميلات والشخصيات التاريخية والقصور والمصانع… لكنها، من جهة أخرى، وخلافا للواقعية الاشتراكية، فإن المفرطة تواجه الواقع بعقلة المراقب المدرك لكل الجزئيات والتفاصيل” . لهذا نجد فنانين اتجهوا إلى تصوير تلك العوالم الدقيقة، مثل الفنان التشكيلي المغربي عبد الرحيم يامو الذي يصور بشكل صباغي مبهر تلك الكائنات الجرثومية والفيروسية والبكتيرية. فتأتي إذن، هذه التصويرية الجديدة باعتبارها اختيارا واعيا للمظاهر الواقعية والتصوير الممتع والفاتن والمدهش.
ولأن الفوتوغرافيا شكلت ثورة تصويرية كبرى، خلقت بموجبها واقعا موازيا، ينبثق من اللحظة المقتنصة من الزمن، التي تغدو نسخة تغدو أصلا… إذ سيجعلها فنانون كثر من دادائيين وغيرهم أساسا من أساسيات اشتغالهم الفني. إلا أن هذه الواقعية الجديدة سعت إلى إعادة تكرس الواقع في إطار من التكرار. الذي يغدو أيقونة، ليصير الواقع المنسوخ ذا طابع قدسي. وهذا ما نلمحه في أعمال عب الإله الشاهدي، الذي يعمد إلى جعل شخوصه أيقونات تحيط بها هالة من السُدُم، التي تخلق فضاءات بصرية متعددة ولا متناهية، شبيهة بفضاءات جيروم بوش اللامتناهية. تحضر فيها الشخوص باعتبارها مركزية تتوسط العمل في الغالب.
فأعمال هذا الفنان التشكيلي المجرب والساكن في مختبره /ورشته، تسعى إلى تخطي ما يربط الإنسان بالطبيعة من احساسات مباشرة. فهو يرنو إلى تسجيل ما تعجز عنه الفوتوغرافيا. أي تلك الأبعاد الإنسانية العميقة، تلك الطبقات النفسية والسيكولوجية. والتي يستحضرها عبر تلك التموجات والتداخلات اللونية. الناتجة عن كيمياء صباغية خاصة بالفنان في مختبره الخاص. إذ يعمد إلى صناعة صباغاته الخاصة وألوانه المتفردة، عبر اشتغال كيميائي رفقة مختصين.
لهذا ليس اختياره للوحة وإطاراتها، سجنا داخلها، أو عدم القدرة على القفز من أسوارها الهشة، والتجريب خارج القماشة. بل لأنه تمكن أن يجد خلطته السحرية في اللون والعمل، إلى جانب ما توفره له من إمكانيات التجريب الصباغي، كاختيار حر ولامشروط. إذ أننا نجد عبد الإله الشاهدي قد انعطف قليلا عن اللوحة، ليجرب أساليب جد معاصر، تبتغي سرية وكمالا، من حيث اعتماده الدائم على كيميائية اللون وساحريته. إذ يضج مختبره بالعديد من “الرسوم الأولية” esquisses لآخر اهتماماته الفنية المتعلقة بإنتاج أعمال ذات تغيرات ضوئية، سواء أحواضه المائية الشفافة المعتمدة على خليط بين الصباغة ومواد التثبيت، أو تلك المعتمدة على حرارة الإنارة لتغيّر ألوانها تبعا لجو الغرفة.
فبالتالي تتداخل في أعمال هذا الفنان، ملامح فنية عدة تتشابك فيها التصويرية الصباغية المفرطة والسوريالية، وبالتقنية وأبعادها اللامرئية. إذ تتحول إلى إبداعية تتعلق بتحول أنطولوجي مرتبط بأفق ميتافيزيقي للتقنية، وأفق الفن المعاصر بكل ما يستعدي معه من تحكم بكل ما هو بصري.
عودة إلى البدء، وفي البدء كانت الصورة. والصورة هنا في كامل حلولها وتجسيدها البصري، الذي يتقابل مع الواقع ويضاهيه. إلا أنه يهرب منه إلى سوريالية تبتغي إنشاء تَمَثُلات نفسية، أو فضاءات لامتناهية، تدخل الصورة /الوجه المرسوم في عوالم من الأحلام، باعتبار الفن نتيجة أحلام تسكن الكائن /الفنان. لتغدو الواقعية المفرطة داخل أعمال الشاهدي، نوعا من السيمولاكر؛ إلا أنه لا يحضر بصفته نسخة النسخة، أو النسخة المشوهة، أو باعتباره نسخة الأصل. بل يحضر باعتباره واقعا: واقعا بديلا.. وموازيا.. بل واقعا قائما بذاته لأنه له تفاصيله وجزئيته الخاصة: واقعا سحريا؛ يشابه قصص غارسا ماركيز وعوالم المائة سنة. كأن الفنان يجسد تلك الرؤية النيتشاوية الساعية إلى إنقاذ الكائن من “حقائق الواقع” القاتلة، عبر خلق “وهم” illusion، من حيث أن الفن هو خالق لأوهام كبدائل عن مأساوية الواقع.
ليست أعمال عبد الإله الشاهدي أعمالا فنية تصويرية تتبع مآزق الكلاسيكية وهندسيتها وحساباتها الأولمبية، التي تجعل الفن حبيس حسابات دقيقة، لا تترك للفنان متسعا من اللهو واللعب والمرح، الذي يجعل العمل منبثقا من الذات الإنسانية الفنانة، باعتبارها منطلق الفن لا العالم الخارجي… فالفنان المعاصر لا يسعى إلى المحاكاة بل إلى إعادة الصياغة والتشكيل والخلق.
فالعمل الفني هو نتاج مآزق الذات وحالتها الوجدانية… لا ما يمليه الواقع الخارجي. فيصير نوعا من التشظي، إن صح اصطلاحنا هذا. فالعمل الفني كما يخبرنا جاك دريدا، هو “رأب للصدع والتشقق وضمد الجراح وعلاج للذات المتشظية”. في ارتباط بتصور هيدغر الرائي بكون العمل الفني تعود حقيقته إلى الكينونة.. كينونة الفنان بالتحديد. أي الكينونة المتشظية، السائرة إلى الهاوية.
هذا التشظي وهذه الهاوية يضمد فتقهما عبد الإله الشاهدي بما استطاعه من تداخلات سوريالية تملأ الفراغات، ولا تملأها في ذات الآن. لأنها فراغات متوالدة لا تنفك تتوالد وتتوسع. إلا أن الملء هنا، سعي إلى اسقاط الذات باعتبارها طبقات نفسية أقصاها الجنون، الذي يرى فيه نيتشه أقصى الفنية. الجنون الذي تنكشف فيه الكينونة التي تُردُّ إليها حقيقة الفن والعمل الفني، من حيث أنها هي انكشاف للحقيقية. ما يجعل العمل الفني بديلا عن الواقع وحقائقه التي تغدو مطلقة، ومعها يصير الإنسان رهين روتين لا ينفك منه.
أما اختيار عبد الإله الشاهدي للأنثى كمرتكز اشتغل فني في جل لوحاته، أي كشكل دال لديه، فباعتبارها الأصل، وباعتبارها أقصى الألوهية المتجسدة في الكائن البشري، إذ تأتي محملة بالأبعاد الحضارية والميثولوجية العتيقة، التي ألهت المرأة وجعلت منها إلهة تُعبد، لاعتبارها دلالة الصيرورة والديمومة والخلق. فهذا الفنان العاشق للأنثى نتاجا لعلاقة القرب التي جمعت بينه وبين أمه، التي احتفل بها في إحدى أعماله الفنية باعتبارها “أمنا الأرض” ومنها تنبثق الحياة، سيعمد لتصوير والدته على شكل “شجرة الحياة” التي تتفرع عنها المعرفة، في تصوير مفرط بالواقعية من خلال تلك الصورة المجسدة “للأم” بتجاعيدها وثنايا الجلد وملامحها المبهر، وتلك السوريالية التي تشكل تعابير لامتناهية تتداخل عبرها الصور فيما بينها، في توالد للتأويل والدلالة، إذ من فوق رأسها تنبع الحضارة وتتجلى في بهائها المعماري. فصير عمل عبد الإله الشاهدي عملا واقعيا ومنفلتا في الآن نفسه.
هذا ما سيمكنه مؤخرا من التتويج بالجائزة الأولى للفنون التشكيلية التي تسلمها الأكاديمية الإيطالية للفنون العالمية، وجائزة فيكتور هوغو للأعمال الفنية التي تدافع عن القضايا الإنسانية والعادلة، فهذا الفنان الذي يدافع عن المرأة ضد كل ما تشهده من مآس وويلات عنف وتعنيف واحتقار وتنقيص من قيمتها ولامساواة، جعل منها مركز اشتغاله وطرحه الأول الذي يشتغل عليه بشكل استتيقي مبهر وماهر، يتخذ طابعه الجمالي من كونه صور تصير أليغوريا، حيث تمسي النسخة مثالية الحضور، إلى جانب واقعيتها السحرية التي تعتبر أساسا لها وأساس الاشتغال لدى الفنان التشكيلي عبد الإله الشاهدي.